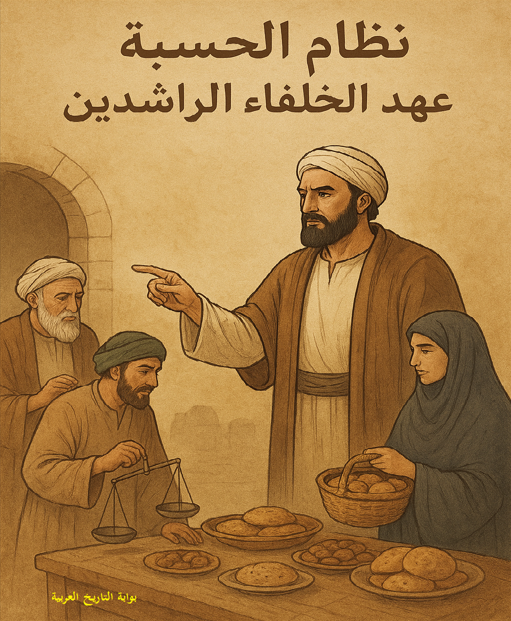نظام الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين: دراسة تاريخية تحليلية
يُعَدّ نظام الحسبة واحدًا من أهم النظم التي عرفها المجتمع الإسلامي منذ نشأته الأولى، إذ ارتبط ارتباطًا وثيقًا بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء ليكون أداة عملية لحماية المجتمع وصيانة قيمه وضبط تفاعلاته الاقتصادية والاجتماعية. وإذا كان عهد النبي ﷺ قد شهد البذور الأولى للحسبة من خلال إشرافه المباشر على الأسواق وتوجيهاته النبوية في المعاملات، فإن عهد الخلفاء الراشدين (11–40هـ/632–661م) قد شكّل المرحلة التأسيسية الحقيقية لترسيخ هذا النظام في بنية الدولة الإسلامية. فقد مارس الخلفاء الرقابة المباشرة بأنفسهم، وعيّنوا محتسبين يتولون تنظيم الأسواق، وحرصوا على أن تكون الحياة الاقتصادية والاجتماعية منضبطة بأحكام الشرع ومقاصده.
وتهدف هذه المقالة إلى إلقاء الضوء على نظام الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين، من خلال تتبع جذوره الدينية والفكرية، وتحليل تطبيقاته العملية في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بيان المجالات التي شملتها الحسبة وخصائصها، وأثرها في تكوين النواة الأولى لمؤسسة إدارية متكاملة ستتبلور في العصور الإسلامية اللاحقة. وسنحاول تقديم قراءة تاريخية تحليلية تعكس قيمة هذا النظام في بناء مجتمع تسوده العدالة الاقتصادية والنزاهة الأخلاقية.
أولًا: الجذور الدينية والفكرية للحسبة في الإسلام
1- الحسبة في القرآن الكريم
تستند الحسبة إلى أصل قرآني متين يتمثل في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [آل عمران: 104]، وقوله سبحانه: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [آل عمران: 110].
هاتان الآيتان تضعان الأساس الديني لفكرة الحسبة باعتبارها وظيفة جماعية لحماية المجتمع من الفساد والانحراف، وضمان العدل والاستقامة في السلوك والمعاملات. وقد ارتبطت هذه الفريضة بالجانب الاقتصادي بشكل خاص، حيث اهتم القرآن بتحريم الغش والربا والاحتكار، كما في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: 1–3].
وهذا النص القرآني يعبّر بجلاء عن الحاجة إلى جهاز أو سلطة تراقب التعاملات في الأسواق وتمنع التطفيف والغش، وهو ما تجسد لاحقًا في مؤسسة الحسبة.
2- الحسبة في السنة النبوية
جاءت السنة النبوية لتوضح ممارسات عملية للحسبة. فقد روي أن رسول الله ﷺ مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فوجد بللًا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء. فقال ﷺ: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني» (رواه مسلم). كما أنه ﷺ ولّى سعيد بن سعيد بن العاص على سوق مكة بعد الفتح، مما يعد أول صورة لتعيين مسؤول رسمي على السوق.
وهذه النصوص والممارسات النبوية تمثل حجر الأساس الذي اعتمده الخلفاء الراشدون في تسيير شؤون الأسواق والمجتمع، فانتقلوا من التطبيق النبوي المباشر إلى مأسسة النظام بما يتناسب مع توسع الدولة وتعقّد شؤونها.
ثانيًا: ملامح نظام الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين
1- الحسبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (11–13هـ)
حين تولّى أبو بكر الصديق الخلافة بعد وفاة النبي ﷺ، كان المجتمع الإسلامي لا يزال في طور البناء، والأسواق محدودة النطاق مقارنة بما ستشهده لاحقًا. ومع ذلك أدرك أبو بكر أهمية استمرار النهج النبوي في الرقابة على المعاملات التجارية وضبط السلوك العام.
كان أبو بكر معروفًا بالزهد والورع، وكان يتفقد الأسواق بنفسه، ويوجه التجار إلى الالتزام بالصدق والأمانة، ويذكّرهم بعاقبة الغش والاحتكار. وقد روي أنه مرّ ببعض الباعة فوجد في سلعهم عيبًا مخفيًا، فقال لهم: “أخبروا الناس بعيوب تجارتكم، فمن غشّ فليس منا”.
كما كان يؤكد على مبدأ حرية السوق في إطار الضوابط الشرعية، أي أنه لم يتدخل في تحديد الأسعار إلا إذا شابها ظلم أو احتكار، وهو منهج مستمد من توجيهات النبي ﷺ عندما رفض التسعير القسري وقال: «إن الله هو المسعِّر القابض الباسط».
يتضح إذن أن الحسبة في عهد أبي بكر اتسمت بالبساطة والرقابة المباشرة، لكنها حافظت على روح العدالة ومنعت الانحراف، وهو ما هيأ الأرضية لمرحلة أكثر تنظيمًا في عهد عمر.
2- الحسبة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (13–23هـ)
يُعَدّ عمر بن الخطاب المؤسس الحقيقي للنظام الإداري في الدولة الإسلامية، إذ اتسعت الدولة في عهده لتشمل العراق والشام ومصر وفارس، الأمر الذي استلزم تطوير آليات الحسبة.
أ- تفقده المباشر للأسواق: كان عمر يتفقد الأسواق بنفسه ليلًا ونهارًا، ويُعرف عنه شدته في محاسبة التجار. فقد روي أنه مرّ بتاجر يبيع الخمر سرًا، فأمر بإراقتها، وضربه عقوبة. كما أنه كان يراقب جودة الطعام، وذات مرة وجد لبنًا مغشوشًا بالماء، فقال للبائعة: “اتقي الله ولا تغشي المسلمين”، ثم أمر بعقوبة من اعتاد الغش.
ب- تعيين المحتسبين: ابتكر عمر خطوة مهمة تمثلت في تعيين مسؤولين رسميين للإشراف على الأسواق، ومن أبرزهم الشفاء بنت عبد الله العدوية التي وُلِّيت سوق المدينة، وهو حدث تاريخي بالغ الأهمية يدل على مرونة النظام الإداري وقدرته على الاستفادة من كفاءة النساء في مجالات الإصلاح الاجتماعي.
ج- مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار: رغم تمسكه بمبدأ عدم التدخل المباشر في تحديد الأسعار، إلا أن عمر كان يتدخل إذا وقع غبن واضح أو احتكار. وقد شدد على منع تخزين الطعام وقت الحاجة، وفرض عقوبات رادعة على المحتكرين.
بهذا يكون عمر قد وضع اللبنات الأولى لمأسسة الحسبة كنظام إداري، يتجاوز الرقابة الفردية إلى جهاز منظم يشارك فيه محتسبون معينون بقرار من الخليفة.
3- الحسبة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه (23–35هـ)
شهد عهد عثمان توسعًا اقتصاديًا كبيرًا نتيجة الفتوحات وتدفق الأموال إلى بيت المال، وهو ما انعكس على الأسواق الإسلامية التي ازدادت نشاطًا وتعقيدًا.
أ- تأكيد الشفافية: كان عثمان يحث التجار على الصدق، ويشدد على ضرورة الإعلان عن عيوب السلع. وقد روي أنه مرّ بسوق المدينة فوجَد رجلًا يُخفي عيبًا في ثوبه، فقال: “أظهر عيب متاعك، فإن الغش لا يبارك الله فيه”.
ب- محاربة الاحتكار: تذكر المصادر أن عثمان كان من أشد الخلفاء رفضًا للاحتكار، واعتبره ظلمًا للمجتمع، حتى إنه كان يتدخل شخصيًا في أوقات الأزمات لإلزام التجار ببيع مخزوناتهم وعدم رفع الأسعار بغير وجه حق.
ج- تطوير سلطة المحتسب: في عهده، بدأ يتبلور منصب المحتسب كشخصية رسمية معروفة، لا مجرد متطوع أو ناصح، بل موظف يتقاضى راتبًا من بيت المال، ما يعكس تطورًا إداريًا مهمًا للحسبة.
4- الحسبة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه (35–40هـ)
رغم أن خلافة علي اتسمت بالاضطرابات السياسية والحروب الداخلية (الجمل، صفين، النهروان)، فإنه لم يغفل عن أهمية الحسبة، بل مارسها بشكل بارز.
أ- الرقابة على المكاييل والموازين: كان علي شديد الحرص على ضبط المقاييس والمكاييل، حتى إنه قال في خطبه: “يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل”. ثم كان يأمر المحتسبين بمراقبة الأسواق ومنع الغش والتطفيف.
ب- حماية الأخلاق العامة: كان يرى أن الحسبة لا تقتصر على الأسواق، بل تشمل أيضًا مراقبة السلوكيات العامة. وكان يحث ولاته على مراقبة أماكن التجمعات، ومنع المنكرات الظاهرة، تحقيقًا لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ج- البعد الإصلاحي: امتاز علي بالجمع بين الحزم والإصلاح، فكان يبدأ بالنصيحة والتوجيه قبل العقوبة، مستندًا إلى قاعدة شرعية تقوم على إصلاح النفوس قبل زجرها.
ثالثًا: المجالات التي شملتها الحسبة في العصر الراشدي
لم تكن الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين مجرد رقابة على الأسواق أو الأسعار، بل شملت مجالات متعددة من حياة المجتمع، جمعت بين الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي. ويمكن أن نرصد أهم هذه المجالات فيما يلي:
1- ضبط الأسواق والتجارة
كان السوق هو القلب النابض للحياة الاقتصادية في المدينة وسائر الأمصار الإسلامية، ومن هنا كان الاهتمام به كبيرًا.
تنظيم أماكن البيع: عمل الخلفاء على تنظيم أماكن الأسواق وتخصيص أماكن للحرفيين والبائعين، منعًا للفوضى. وقد اتخذ عمر بن الخطاب إجراءات لتحديد مواقع الأسواق في الكوفة والبصرة، بحيث تكون قريبة من العمران ويسهل مراقبتها.
الإشراف المباشر: كان الخلفاء أنفسهم يزورون الأسواق بين حين وآخر، ويتحققون من نزاهة التعاملات. وهذا يعكس الطابع المباشر للحسبة، الذي يجعل رأس الدولة شريكًا في الرقابة.
ضبط العقود التجارية: تدخل الخلفاء لمنع العقود الفاسدة كالبيع بالنجش (رفع السعر صوريًا) أو بيع ما ليس في ملك البائع، أو بيع الغرر. وقد اعتبروا هذه الممارسات ضربًا من أكل أموال الناس بالباطل.
2- الرقابة على المكاييل والموازين
من أبرز مجالات الحسبة في العصر الراشدي مراقبة المكاييل والموازين، إذ كان الغش فيها من أكبر مظاهر الظلم الاقتصادي.
عمل الخلفاء على إلزام التجار باستخدام موازين معتمدة، ومنع أي تلاعب فيها؛ ففي عهد عمر بن الخطاب، وُضعت مقاييس رسمية للكيل، وأمر أن تحفظ في بيت المال ليُقاس عليها. كما شدد علي بن أبي طالب على هذه القضية، حتى جعلها محورًا في خطبه، وعدّها معيارًا للعدل في المعاملات، واعتبر التلاعب فيها صورة خفية من الربا والغش.
وقد ساعدت هذه الرقابة على إرساء الثقة بين أفراد المجتمع، وضمان عدالة التبادل التجاري، وهو ما أسهم في الاستقرار الاقتصادي للدولة الناشئة.
3- مراقبة الأخلاق والسلوك العام
لم تكن الحسبة مقتصرة على الأسواق، بل شملت المجال الاجتماعي والأخلاقي.
النهي عن المنكرات الظاهرة: مثل شرب الخمر، وإقامة مجالس اللهو، وارتكاب الفواحش. وكان الخلفاء يوجّهون ولاتهم بتتبع هذه الأمور وردعها.
الأمر بالمعروف: مثل الحث على الصدق والأمانة، وتشجيع الناس على أداء الصلوات في جماعة، والمشاركة في أعمال الخير.
حماية القيم العامة: فقد كان الخليفة ينظر إلى نفسه باعتباره مسؤولًا عن “صيانة المجتمع” لا عن “حماية الاقتصاد” فقط.
ومن أشهر الوقائع أن عمر بن الخطاب كان يجوب طرق المدينة ليلًا ليتفقد أحوال الناس، فيأمر بالخير وينهى عن المنكر، مما جعل الحسبة تتجاوز كونها وظيفة إدارية إلى كونها وظيفة أخلاقية ذات بُعد تربوي.
4- حماية الحقوق ومنع الاحتكار
كان الاحتكار من أخطر الظواهر الاقتصادية في المجتمعات القديمة، لذلك حارب الخلفاء الراشدون هذه الظاهرة بشدة:
كان عمر بن الخطاب ينهى التجار عن تخزين الطعام وقت الشدة، ويجبرهم على بيعه في السوق بأسعار عادلة. تابع عثمان بن عفان النهج نفسه، وكان يتدخل أحيانًا لإجبار التجار على إخراج مخزوناتهم حتى لا يتضرر عامة الناس. كما أكد علي بن أبي طالب على مبدأ العدالة الاجتماعية، واعتبر أن الاحتكار يضر بكرامة الفقراء ويقوّض التوازن الاجتماعي.
وهكذا ارتبطت الحسبة في هذا المجال بتحقيق مبدأ العدالة، الذي يُعَدّ من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية.
5- المجالات الإدارية والتنظيمية
إلى جانب الاقتصاد والأخلاق، شملت الحسبة جوانب تنظيمية أخرى، مثل:
النظافة العامة: حيث وُجّه الناس للحفاظ على نظافة الطرقات والأسواق.
تنظيم المهن والحرف: مثل مراقبة الصناعات المرتبطة بالحياة اليومية (الخبازين، الحدادين، النجارين) للتأكد من مطابقة إنتاجهم للمواصفات.
متابعة الأسعار بصورة غير مباشرة: أي من خلال معرفة العرض والطلب ومنع التلاعب، من دون فرض تسعير إجباري إلا للضرورة.
يتضح مما سبق أن الحسبة في العصر الراشدي كانت شاملة لمختلف جوانب الحياة: اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، وإدارية، وهو ما يعكس شمولية الإسلام في معالجة قضايا المجتمع.
رابعًا: خصائص نظام الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين
من خلال تتبع التجربة الراشدية في تطبيق الحسبة، يمكن استخلاص عدد من الخصائص التي تميزت بها هذه المرحلة المبكرة من التاريخ الإسلامي:
1- الطابع المباشر والعملي: كانت الحسبة في بدايتها ذات طابع بسيط ومباشر، حيث كان الخليفة نفسه يتولى الرقابة على الأسواق والسلوكيات، كما كان يعين أشخاصًا بقرارات فردية لمساعدته في ذلك. ولم يكن ثمة جهاز بيروقراطي معقد، بل كان التركيز على الممارسة اليومية المباشرة التي تمكّن من معالجة الانحرافات في حينها.
2- الدمج بين الجانب الديني والاقتصادي: لم تكن الحسبة مجرد نظام اقتصادي، بل كانت مرتبطة بالجانب الديني، إذ تستند إلى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الدمج جعل الحسبة وسيلة لتحقيق العدالة المادية (منع الغش والاحتكار) إلى جانب العدالة الأخلاقية (النهي عن الفساد والمنكرات).
3- الأسلوب الإصلاحي قبل العقوبة: من الخصائص البارزة للحسبة في العهد الراشدي أنها ركزت على الإصلاح قبل الزجر. فقد كان الخليفة أو المحتسب يبدأ بالنصيحة والتذكير، فإذا لم يجد ذلك نفعًا، لجأ إلى العقوبة. وهذا الأسلوب يعكس البعد التربوي والأخلاقي للنظام.
4- شمولية مجالات الحسبة: اتسعت الحسبة لتشمل الاقتصاد، والأخلاق، والإدارة العامة، وهو ما يعكس شمولية التصور الإسلامي للرقابة الاجتماعية. فلم تكن الحسبة مجرد جهاز لحماية الأسواق، بل كانت منظومة لحماية المجتمع من الفساد والانحراف في أبعاده المختلفة.
5- المرونة والتكيف مع الظروف: اتسمت الحسبة في هذه المرحلة بالمرونة؛ إذ تطورت من رقابة بسيطة في عهد أبي بكر إلى تنظيم مؤسسي في عهد عمر وعثمان، ثم امتدت لتشمل أبعادًا أخلاقية أوسع في عهد علي. هذا التكيف يعكس حيوية النظام وقدرته على التطور بحسب احتياجات الدولة والمجتمع.
خامسًا: أثر التجربة الراشدية على العصور الإسلامية اللاحقة
لقد شكّلت التجربة الراشدية الأساس الذي بُني عليه نظام الحسبة في العصور الأموية والعباسية وما بعدها، حيث تحولت الحسبة من ممارسة فردية إلى مؤسسة إدارية متكاملة.
1- من الرقابة الفردية إلى المؤسسة الرسمية: في العصر الراشدي، كانت الحسبة في معظمها رقابة مباشرة من الخليفة أو من ينيبه. لكن هذه الممارسة وضعت اللبنات الأولى لظهور منصب المحتسب باعتباره موظفًا رسميًا، وهو ما تجسد بشكل أوضح في العصر الأموي، حين صار للمحتسب ولاية خاصة يُعيَّن لها بمرسوم رسمي.
2- صياغة القواعد الفقهية للحسبة: اعتمد الفقهاء في العصور التالية على التجربة الراشدية لتأسيس نظرية فقهية متكاملة للحسبة. فنجد مثلًا الماوردي في “الأحكام السلطانية” يستند إلى ما فعله الخلفاء الراشدون ليحدد صلاحيات المحتسب. وهذا يثبت أن الممارسة التاريخية في عصر الراشدين كانت مرجعًا تشريعيًا لاحقًا.
3- الحسبة والضبط الاجتماعي: أعطت التجربة الراشدية نموذجًا ناجحًا لارتباط السلطة بالرقابة الأخلاقية. ففي العصور اللاحقة، ظل المحتسب مسؤولًا عن حماية القيم العامة، وضبط الأسواق، ومنع المنكرات، وهو ما يمثل امتدادًا مباشرًا لما أرساه الخلفاء الراشدون.
4- الأثر في تشكيل الوعي الإسلامي: لم يكن أثر الحسبة مقتصرًا على النظم الإدارية، بل امتد ليشكّل جزءًا من الوعي الجمعي للمسلمين. فقد ترسخ في ذهن المسلم أن الدولة مسؤولة عن حماية السوق والأخلاق معًا، وأن العدالة لا تتحقق إلا بالرقابة المستمرة على تصرفات الأفراد.
***
يتضح من خلال دراسة نظام الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين أنه كان إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمع الإسلامي الناشئ. فقد جمع بين البعد الديني والبعد الاقتصادي والاجتماعي، وأسهم في حماية السوق من الغش والاحتكار، وصيانة الأخلاق العامة من الانحراف.
وقد تميزت التجربة الراشدية بعدة خصائص أبرزها: الرقابة المباشرة، الطابع الإصلاحي، والشمولية، إضافة إلى المرونة التي مكنتها من التكيف مع توسع الدولة وتغير الظروف.
وإذا كانت هذه التجربة في بدايتها بسيطة وغير مؤسسية، فإنها وضعت الأسس الأولى لمؤسسة الحسبة التي ستتطور لاحقًا في العصور الأموية والعباسية إلى جهاز إداري رسمي، له صلاحيات محددة وموظفون مختصون.
إن دراسة نظام الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين لا تكشف فقط عن بعد تاريخي، بل عن تصور إسلامي متكامل للرقابة الاجتماعية والاقتصادية، قائم على الدمج بين القيم الدينية والعدالة الدنيوية. وهذا التصور ظل حاضرًا في الفكر الإسلامي والفقه الإداري لقرون طويلة، مما يبرز أصالة التجربة الراشدية وريادتها في بناء مؤسسات الدولة الإسلامية.